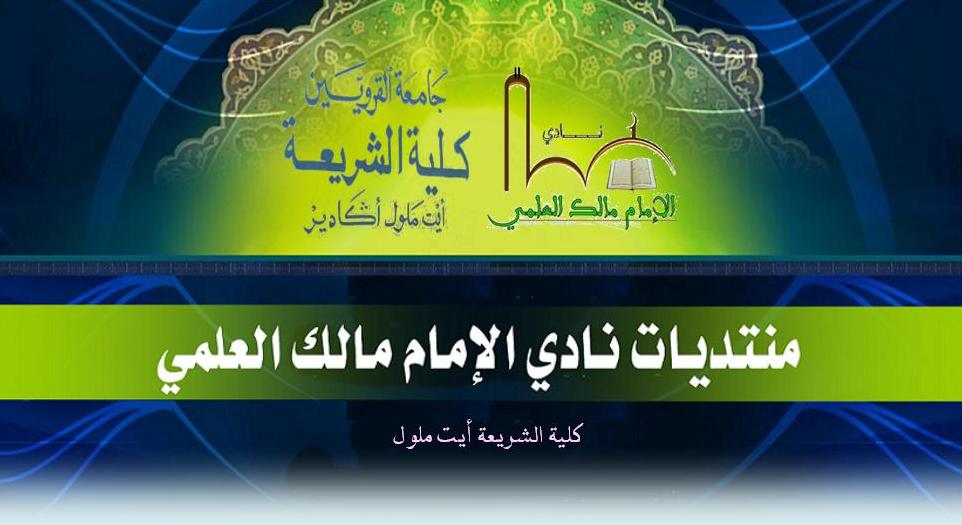موقف المفسرين من الآيات الكونية
القرآن يحض علي تدبر آياته ومعانيه والاجتهاد في تفسيره ضرورة
-- طال الجدل حول جواز تفسير الاشارات الكونية الواردة في كتاب الله على أساس من معطيات علوم العصر وفنونه, وتفاوتت مواقف العلماء من ذلك تفاوتا كبيرا بين مضيقين وموسعين ومعتدلين مما يمكن أن نوجزه فيما يلي:
موقف المضيقيــــــــــن: وهو الموقف الذي يري أصحابه أن تفسير الآيات الكونية الواردة في كتاب الله, علي ضوء ماتجمع لدي الانسان من معارف هو نوع من التفسير بالرأي الذي لا يجوز استنادا إلي أقوال منسوبة لرسول الله (عليه الصلاة والسلام) منها:
من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
ومن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وإلي أقوال منسوبة إلي كل من الخليفتين الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنهما من قول الأول: أي سماء تظلني, وأي أرض تقلني ان قلت في كتاب الله برأيي. وقول الثاني اتبعوا ماتبين لكم من هذا الكتاب فأعملوا به, ومالم تعرفوه فكلوه إلى ربه. وكذلك استنادا إلي قول كل من سعيد بن المسيب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح المنقول عن الأول انا لا نقول في القرآن شيئا. وإلي الثاني لقد أدركت فقهاء المدينة وأنهم ليعظمون القول في التفسير.
وإلي القول المنسوب إلي مسروق بن الأجدع( رضي الله عنه): اتقوا التفسير فانما هو الرواية عن الله.
الرد على المضيقيــــــن:
فات أصحاب هذا الموقف المضيق أن المقصود بالرأي في الحديث هو الهوى, لا الرأي المنطقي المبني علي الحجة الواضحة والبرهان المقبول, ويؤكد ذلك عبارة "بغير علم" التي وردت في الحديث الثاني هذا بغض النظر عن كون الحديثين قد اعتبرا من ضعاف السند.
كذلك فاتهم أن ماقد ورد علي لسان بعض الصحابة والتابعين مما يوحي بالتحرج من القول في القرآن الكريم بالرأي الاجتهادي, انما هو من قبيل الورع, والتأدب في الحديث عن كلام الله, خاصة أنهم كانوا قد فطروا علي فهم اللغة العربية, وفطنوا بها وبأسرارها, ودرجوا علي عادات المجتمع العربي ـ وألموا بأسباب النزول, وعايشوا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن قرب وهو الموصول بالوحي ــ وسمعوه صلي الله عليه وسلم ــ وهو يتلو القرآن الكريم ويفسره, واستعانوا به علي فهم ماوقفوا دونه, وأدركوا تفاصيل سنته الشريفة في ذلك وغيره, فهل يمكن لمن توافر له كل ذلك أن يكون له مجال للاجتهاد بالرأي؟ خاصة أن العصر لم يكن عصر تقدم علمي كالذي نعيشه, وأنهم كانوا لايزالون قريبي عهد بالجاهلية التي كان قد خيم فيها علي شبه الجزيرة العربية, بل وعلي العالم أجمع ركام من العقائد الفاسدة, والتصورات الخاطئة, والافكار السقيمة, والأوهام والأساطير... ولم يسلم من ذلك الركام أحد, حتى أصحاب الحضارات البائدة.
وأن العصر كان عصر انتشار للإسلام, ودخول للكثيرين من أصحاب العقائد واللغات الأخري في دين الله أفواجا, ومعهم خلفياتهم الفكرية الموروثة, والتي لم يتمكنوا من التخلص منها كلية بمجرد دخولهم في الإسلام, وأن أعدادا غير قليلة من هؤلاء كانوا قد دخلوا الاسلام ليأتمروا به ويتآمروا عليه, ويكيدوا له, بتأويل القرآن علي وجوه غير صحيحة, وبتفتيت وحدة الصف الاسلامي, وبث بذور الفرقة فيه, وكان من نتائج ذلك كله هذا الفكر الغريب الذي دس علي المسلمين والذي عرف فيما بعد بالاسرائيليات نسبة إلي السلالات الفاسدة من بني اسرائيل( أي اليهود) الذين كثر النقل عنهم, وكثر دسهم على دين الله, وعلي أنبيائه ورسله (صل الله وسلم عليهم أجمعين), وكان من نتائجه كذلك بروز الشيع والفرق والطرائق المختلفة, ومحاولة كل فرقة منها الانتصار لرأيها بالقرآن... وهذا هو الهوى الذي عبر عنه بالرأي فيما نسب من أقوال إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وإلى عدد من صحابته وتابعيهم( عليهم رضوان الله أجمعين).
اللهم فقهه في الديــــــن:كذلك فقد فات هؤلاء, وهم ينادون بعدم الاجتهاد بالرأي في فهم كتاب الله, والوقوف عند حدود المأثور وهو مانقل عن رسول الله صل الله عليه وسلم مباشرة, أو عن صحابته الكرام, أو عمن عاصر الصحابة من التابعين, موكلين مالم يفسره التراث المنقول إلى الله وهو ماعرف بمنهج التفسير بالمأثور أو التفسير بالمنقول, وكلنا يعلم أن التفسير بالمأثور لم يشمل القرآن كله, فلحكمة يعلمها الله ــ وقد ندرك طرفا منها اليوم ــ لم يقم رسول الله صل الله عليه وسلم بالتنصيص على المراد في كل آية من آيات القرآن الكريم, وأن صحابته الكرام كانوا يجتهدون في فهم مالم ينص عليه, وكانوا يختلفون في ذلك ويتفقون, وأن من الثابت أنه( صل الله عليه وسلم) قد صوب رأي جماعة من أصحابه حين فسروا آيات من كتاب الله, وانه قد دعا لابن عباس بقوله: "اللهم فقهه في الدين, وعلمه التأويل", وان ذلك وغيره من الأقوال المأثورة قد اتخذ دليلا علي جواز الاجتهاد في التفسير في غير ما حدده رسول الله( صل الله عليه وسلم) فمما يروى عن علي( رضي الله عنه) حين سئل: هل خصكم رسول الله( صل الله عليه وسلم) بشيء؟ انه قال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة, وفهم يؤتاه الرجل في كتابه وهذا يؤكد على أن فهم المسلمين لدلالة آيات القرآن الحكيم وتدبر معانيها هي ضرورة تكليفية لكل قادر عليها مؤهل للقيام بها, وذلك يقرره الحق تبارك وتعالي في قوله وهو أحكم القائلين:
"كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب"( ص29)
وهذه الآية الكريمة, وكثير غيرها من الآيات القريبة في المعنى ـ أمر صريح من الله تبارك وتعالي بتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيها, فالقرآن ينعي على أولئك الذين لا يتدبرونه, ولا يستنبطون معانيه, وهذه آياته
"أفلا يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به, ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم....."[ النساء الآيتان81-82].
"أفلا يتدبرون القرءان أم على قلوب أقفالها"( محمد الآية ـ24)
وقد ساق الإمام الغزالي( يرحمه الله) الأدلة على جواز فهم القرآن بالرأي( أي بالاجتهاد) ثم أضاف: فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن مجالا رحبا, ومتسعا بالغا, وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهي الادراك فيه.
وبناء على ذلك فقد أجاز الغزالي لكل إنسان أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله, ولو أن المبالغة في استخدام تلك الرخصة قد أفرزت نتاجا لم يكن كله مستساغا مقبولا لدى العلماء, مطابقا لمقاصد القرآن الكريم في الهداية, فقد خرج قوم من المفسرين بالآيات القرآنية( إما عن عمد واضح أو جهل فاضح) إلى مالا يقبله العقل القويم, والصحيح المنقول عن رسول الله( صل الله عليه وسلم) وعن أصحابه والتابعين لهم, وعن المنطق اللغوي وأساليب العرب في الأداء حقيقة ومجازا, وذلك لانطلاق الفرق المختلفة والمذاهب المتنوعة من غير أهل السنة والجماعة( من فقهية وكلامية, وصوفية وباطنية) من منطلق التعصب لمذاهبهم ومحاولاتهم إخضاع التفاسير لخدمة مللهم ونحلهم, مما أدى إلى الموقف المتشدد من القول في القرآن بالرأي, ومن ثم رفض تفسير الآيات الكونية الواردة في كتاب الله على أساس من معطيات المعارف الإنسانية المكتسبة في حقل العلوم البحتة والتطبيقية.
الدعوة إلى الاجتهاد في التفسير:هناك أعداد كبيرة من علماء المسلمين الذين اقتنعوا بضرورة الاجتهاد في تفسير كتاب الله, ولكنهم حصروا ذلك في مناهج محددة منها المنهج اللغوي الذي يهتم بدلالة الألفاظ, وطرائق التعبير وأساليبه والدراسات النحوية المختلفة, والمنهج البياني الذي يحرص على بيان مواطن الجمال في أسلوب القرآن, ودراسة الحس اللغوي في كلماته, والمنهج الفقهي الذي يركز علي استنباط الأحكام الشرعية والإجتهادات الفقهية, كما أن من هؤلاء المفسرين من نادي بالجمع بين تلك المناهج في منهج واحد عرف باسم المنهج الموسوعي( أو المنهج الجمعي), ومنهم من نادي بتفسير القرآن الكريم حسب الموضوعات التي اشتمل عليها, وذلك بجمع الآيات الواردة في الموضوع الواحد في كل سور القرآن, وتفسير واستنباط دلالاتها استنادا إلى قاعدة: أن القرآن يفسر بعضه بعضا, وقد عرف ذلك باسم المنهج الموضوعي في التفسير.
من مبررات رفض المنهج العلمي للتفسير:اما المنهج العلمي في التفسير والذي يعتمد على تفسير الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله تعالى حسب اتساع دائرة المعرفة الإنسانية من عصر إلى عصر وتبعا للطبيعة التراكمية لتلك المعرفة فقد ظل مرفوضا من غالبية المجتهدين في التفسير وذلك لأسباب كثيرة منها:
(1) أن الإسرائيليات كانت قد نفذت أول ما نفذت إلى التراث الإسلامي عن طريق محاولة السابقين تفسير تلك الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله, وذلك لأن الله تعالى قد شاء أن يوكل الناس في أمور الكشف عن حقائق هذا الكون إلى جهودهم المتتالية جيلا بعد جيل, وعصرا بعد عصر..., ومن هنا جاءت الإشارات الكونية في القرآن الكريم بصيغة مجملة, يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني, وتظل تلك المعاني تتسع باستمرار في تكامل لا يعرف التضاد, ومن هنا أيضا لم يقم رسول الله( صل الله عليه وسلم) بالتنصيص على المراد منها في أحاديثه الشريفة, التي تناول بها شرح القرآن الكريم, ولكن لما كانت النفس البشرية تواقة دوما إلى التعرف على أسرار هذا الوجود, ولما كان الإنسان قد شغل منذ القدم بتساؤلات كثيرة عن نشأة الكون, وبداية الحياة, وخلق الإنسان ومتى حدث كل ذلك, وكيف تم, وما هي أسبابه؟, وغير ذلك من أسرار الوجود.., فقد تجمع لدي البشرية في ذلك تراث ضخم, عبر التاريخ اختلط فيه الحق بالباطل, والواقع بالخيال, والعلم بالدجل والخرافة, وكان أكثر الناس حرصا علي هذا النوع من المعرفة المكتسبة هم رجال الدين في مختلف العصور, وقد كانت الدولة الاسلامية في أول نشأتها محاطة بحضارات عديدة تباينت فيها تلك المعارف وأمثالها ثم بعد اتساع رقعة الدولة الاسلامية واحتوائها لتلك الحضارات المجاورة, ودخول أمم من مختلف المعتقدات السابقة على بعثة المصطفى ـ صل الله عليه وسلم ـ إلى دين الله.. ووصول هذا التراث إلى قيامهم على ترجمته ونقده والإضافة إليه. حاول بعض المفسرين الإستفادة به في شرح الإشارات الكونية الواردة بالقرآن الكريم فضلوا سواء السبيل لأن العصر لم يكن بعصر تطور علمي كالذي نعيشه اليوم, ولأن هذا التراث كان أغلبه في أيدي اليهود, وهم الذين ائتمروا على الكيد للاسلام منذ بزوغ فجره, وأن النقل قد تم عمن أسلم ومن لم يسلم منهم, على الرغم من تحذير رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولاتكذبوهم, فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه, وأما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
ويفسر ابن خلدون أسباب نقل هذه الإسرائيليات بقوله: والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب, ولاعلم, وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية, وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية: في أسباب المكونات, وبدء الخليقة, وأسرار الوجود, فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم, ويستفيدون منهم, وهم أهل التوراة من اليهود, ومن تبع دينهم من النصاري, وأهل التوارة الذين بين العرب يومئذ وهم بادية مثلهم ولايعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب, ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية, فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لاتعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها...
2 ــ أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية ربانية, أي كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات, بمعنى آخر هو كتاب دين الله الذي أوحي به إلى سائر أنبيائه ورسله وتعهد الله تعالى بحفظه فحفظ, فعلى ذلك لابد من التأكيد أن القرآن الكريم ليس كتاب علم تجريبي, وأن الإشارات العلمية التي وردت به جاءت في مقام الإرشاد والموعظة لا في مقام البيان العلمي بمفهومه المحدد, وأن تلك الإشارات ــ على كثرتها ــ جاءت في أغلب الأحيان مجملة, وذلك بهدف توجيه الإنسان إلى التفكير والتدبر وإمعان النظر في خلق الله, لا بهدف الإخبار العلمي المباشر.
3 ــ أن القرآن الكريم ثابت لايتغير بينما معطيات العلوم التجريبية دائمة التغير والتطور وأن ما تسمى بحقائق العلم ليست سوى نظريات وفروض يبطل منها اليوم ما كان سائدا بالأمس, وربما في الغد ماهو سائد اليوم, وبالتأكيد فلا يجوز الرجوع إليها عند تفسير كتاب الله العزيز لأنه لايجوز تأويل الثابت بالمتغير.
4 ـأن القرآن الكريم هو بيان من الله, بينما معطيات العلوم التجريبية لاتعدو ان تكون محاولة بشرية للوصول إلى الحقيقة, ولايجوز ــ في ظنهم ـ رؤية كلام الله في إطار محاولات البشر, كما لايجوز الإنتصار لكتاب الله تعالى بمعطيات العلوم المكتسبة لأن القرآن الكريم بصفته كلام الله هو حجة على البشر كافة, وعلى العلم وأهله.
5 ــ أن العلوم التجريبية تصاغ في أغلب دول العالم اليوم صياغة تنطلق كلها من منطلقات مادية بحت, تفكر أو تتجاهل الغيب, ولا تؤمن بالله, وأن للكثيرين من المشتغلين بالعلوم الكونية( البحت والتطبيقية) مواقف عدائية واضحة من قضية الإيمان بالله تعالى وبملائكته وكتبه ورسله, وبالقدر خيره وشره, وبحياة البرزخ وبالبعث والنشور والحساب وبالحياة الخالدة في الدار الآخرة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا.
6 ــ أن بعض معطيات العلوم التجريبية قد يتباين مع عدد من الأصول الثابتة في الكتاب والسنة نظرا لصياغتها من منطلقات مادية بحت منكرة لكل حقائق الغيب أو متجاهلة لها.
7 ـ أن عددا من المفسرين الذين تعرضوا لتأويل بعض الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله قد تكلفوا في تحميل الآيات من المعاني مالا تحمله في تعسف واضح وتكلف مفتعل على أعناق الكلمات والآيات وتحميلها من المعاني مالا تحمله.
الرد على الرافضين للمنهج العلمي في التفسير:
إن حجج المعارضين للمنهج العلمي للتفسير والتي أوردناها في الفقرات السابقة هي كلها حجج مردودة حجة بحجة كما يلي:
1 ــ انه لاحاجة بنا اليوم إلى الإسرائيليات في تفسير آيات الكونيات, لأن الرصيد العلمي في مختلف تلك المعارف قد بلغ اليوم شأوا لم يبلغه من قبل, وإذا كان من استخدم الإسرائيليات في تفسيره من الأوائل قد ضل سواء السبيل, فإن من يستخدم حقائق العلم الثابتة, ومشاهداته المتكررة في شرح تلك الآيات لابد أن يصل إلى فهم لها لم يكن من السهل الوصول إليه من قبل, وأن يجد في ذلك من صور الإعجاز مالم يجده السابقون, تأكيدا لوصف رسول الله صل الله عليه وسلم للقرآن بأنه لاتنقضي عجائبه ولايخلق من كثرة الرد.
3 ــ أنه لاتعارض البتة بين كون القرآن الكريم كتاب هداية ربانية, وإرشادا إلهيا ودستور عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملات وكتاب تشريع سماوي يشمل نظاما كاملا للحياة, وبين احتوائه على عدد من الإشارات العلمية الدقيقة التي وردت في مقام الاستدلال على عظمة الخالق وقدرته في إبداعه للخلق, وقدرته على إفناء ما قد خلق, وإعادة كل ذلك من جديد, وذلك لأن الإشارات تبقى بيانا من الله, خالق الكون ومبدع الوجود, فلابد وأن تكون حقا مطلقا, لأنه من أدرى بالخليقة من الخالق سبحانه وتعالى. ولو أن المسلمين وعووا هذه الحقيقة منذ القدم لكان لهم في مجال الدراسات الكونية سبق ملحوظ, وثبات غير ملحوق فنحن ندرك اليوم ــ وفي ضوء ماتجمع لنا من معارف في مجال دراسات العلوم البحتة والتطبيقية ــ أن آيات الكونيات في كتاب الله تتسم جميعها بالدقة المتناهية في التعبير والشمول في المعنى, والإطراد والثبات في الدلالة والسبق لكثير من الكشوف العلمية بعشرات المئات من السنين وفي ذلك شهادة قاطعة لايستطيع أن ينكرها جاحد بأن القرآن لايمكن أن يكون إلا كلام الله الخالق.
أما القول بأن تلك الإشارات قد تم سردها بصورة مجملة, فإنها بحق إحدى صور الإعجاز العلمي والبياني في القران الكريم, وذلك لأن كل إشارة علمية وردت فيه قد صيغت صياغة فيها من إعجاز الإيجاز والدقة في التعبير والإحكام في الدلالة, والشمول في المعني ما يمكن الناس على اختلاف ثقافاتهم وتباين مستويات إدراكهم وتتابع أجيالهم وأزمانهم أن يدركوا لها من المعاني ما يتناسب وهذه الخلفيات كلها, بحيث تبقى المعاني المستخلصة من الآية الواحدة يكمل بعضها بعضا في تناسق عجيب.. وتكامل أعجب لأنه تكامل لا يعرف التضاد وهذا عندي من أروع صور الإعجاز في كتاب الله فالإجمال في تلك الإشارات مع وضوح الحقيقة العلمية للأجيال المتلاحقة, كل على قدر حظه من المعرفة بالكون وعلومه هي بالقطع أمر فوق طاقة البشر وصورة من صور الإعجاز لم تتوافر ولايمكن أن تتوافر لغير كلام الله الخالق, ومن هنا كان فهم الناس للإشارات العلمية الواردة بالقرآن الكريم على ضوء مايتجمع لديهم من معارف, فهما يزداد اتساعا وعمقا جيلا بعد جيل, وهذا في حد ذاته شهادة للقرآن الكريم بأنه لاتنتهي عجائبه, ولايبلي على كثرة الرد كما وصفه المصطفى( صل الله عليه وسلم).
وقد أدرك نفر من السابقين ذلك وفي مقدمتهم الإمام الزركشي الذي كتب في كتابه البرهان في علوم القرآن مانصه.." وما من برهان ودلالة وتقسيم, وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به, لكن أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين: أحدهما بسبب ماقاله سبحانه وتعالي:
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم[ سورة ابراهيم:4]
والثاني: أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام, فان استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفمهه الأكثرون لم يتخط إلي الأغمض الذي لايعرفه إلا الأقلون, وكذلك أخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه من أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها مايقنعهم الحجة, وتفهم الخواص من أينائها مايوفي على ما أدركه الخطباء....
ثم يضيف: ومن ثم كان على كل من أصاب حظا في العلم أوفر أن يكون نصيبه من علم القرآن أكثر, لأن عقله حينئذ يكون قد استنار بأضواء العلم, وهؤلاء الذين اهتم القرآن بمناداتهم كلما ذكر حجة على الربوبية والوحدانية, أو أضاف إليهم أولو الألباب والسامعون والمفكرون والمتذكرون تنبيها إلى أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منها.
من هنا كان واجب المتخصصين من المسلمين في كل عصر وفي كل جيل أن ينفر منهم من يستطيع أن يجمع إلى حقل تخصصه إلماما بحد أدنى من علوم اللغة العربية وآدابها, ومن الحديث وعلومه, والفقه وأصوله, وعلم الكلام وقواعده, واحاطة بأسباب النزول, وبالمأثور في التفسير, وباجتهاد السابقين من أئمة المفسرين, ثم يعود هؤلاء إلى دراسة الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله ـ كل فيما يخصه ـ محاولين فهمها في ضوء معطيات العلم وكشوفه, وقواعد المنطق وأصوله حتي يدركوا ما يستطيعون من فهم لكتاب الله حتي تتحقق نبوءة المصطفى( صل الله عليه وسلم) في وصفه لكتاب الله أنه لاتنتهي عجائبه..
(3) إن القول بعدم جواز تأويل الثابت بالمتغير قول ساذج, لأن معناه الجمود على فهم واحد لكتاب الله, ينأي بالناس عن واقعهم في كل عصر, حتى لايستسيغوه فيملوه ويهملوه, وثبات القرآن الكريم.. وهو من السمات البارزة له لايمنع من فهم الاشارات الكونية الواردة فيه على أساس من معطيات العلوم الكونية البحتة منها والتطبيقية, حتى ولو كان ذلك يتسع من عصر إلى آخر بطريقة مطردة, فالعلوم المكتسبة كلها لها طبيعة تراكمية, ولا يتوافر للإنسان منها في عصر من العصور إلا أقدار تتفاوت بتفاوت الأزمنة, وتباين العصور, تقدما واضمحلالا, وهذه الطبيعة التراكمية للمعرفة الانسانية المكتسبة تجعل الأمم اللاحقة أكثر علما ـ بصفة عامة ـ من الأمم السابقة, إلا إذا تعرضت الحضارة الانسانية بأكملها للانتكاس والتدهور.
من هنا كانت معطيات العلوم الكونية ـ بصفة خاصة, والمعارف المكتسبة كلها بصفة عامة ـ دائمة التغير والتطور, بينما كلمات وحروف ـ القرآن الكريم ثابتة لاتتغير, وهذا وحده من أعظم شواهد الإعجاز في كتاب الله.
وعلى الرغم من ثبات اللفظ القرآني, وتطور الفهم البشري لدلالاته ـ مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية جيلا بعد جيل ـ فإن تلك الدلالات يتكامل بعضها مع بعض في اتساق لايعرف التضاد, ولايتوافر ذلك لغير كلام الله, إلا إذا كان المفسر لايأخذ بالأسباب, أو يسيء استخدام الوسائل فيضل الطريق....!! ويظل اللفظ القرآني ثابتا, وتتوسع دائرة فهم الناس له عصرا بعد عصر.. وفي ذلك شهادة للقرآن الكريم بأنه يغاير كافة كلام البشر, وأنه بالقطع بيان من الله.... ولذلك فاننا نجد القرآن الكريم يحض الناس حضا على تدبر أياته, والعكوف على فهم دلالاتها, ويتحدى أهل الكفر والشرك والإلحاد أن يجدوا فيه صورة واحدة من صور الاختلاف أو التناقض على توالي العصور عليه, وكثرة النظر فيه, وصدق الله العظيم إذ يقول:
أفلا يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
[ النساء82]
وإذ يكرر التساؤل التقريعي في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان, ويؤكد ضرورة تدبر القرآن وأنه تعالى قد جعله في متناول عقل الإنسان فيذكر ذلك أربع مرات في سورة القمر حيث يصدع التنزيل بقول الحقتبارك وتعالى:
"ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر"
[ القمر: الايات17 و22 و32 و40]
والذكر هنا ـ كما يجمع المفسرون ـ يشمل التلاوة والتدبر معا, ويشير إلى استمرار تلك العملية مع تبادل العصور وتجدد الأزمان, ومن هنا يبقى النص القرآني ثابتا ويتجدد, فهم الناس له كلما اتسعت دائرة معارفهم ونمت حصيلتهم العلمية, وذلك بالقطع ـ فيما لم يرد في شرحه شيء من المأثور الموثق, وليس في ذلك مقابلة بين كلام الله وكلام الناس ـ كما يدعي البعض ولكنه المحاولة الجادة لفهم كلام الله وهو الذي أنزله الله تعالى للبشر لكي يفهموه ويتعظوا بدروسه, وفهمه في نفس الوقت هو صورة من صور الإعجاز في كتاب الله, لاينكرها إلا جاحد.
أما القول بأن ما يسمي بحقائق العلم ليس إلا نظريات وفروضا, يبطل منها اليوم ما كان سائدا بالأمس, وربما يبطل في الغد ماهو سائد اليوم فهو أيضا قول ـ ساذج لأن هناك فروقا واضحة بين الفروض والنظريات من جهة والقواعد والقوانين من جهة أخرى, وهي مراحل متتابعة في منهج العلوم التجريبية الذي يبدأ بالفروض ثم النظريات وينتهي بالقواعد والقوانين, والفروض هي تفسيرات أولية للظواهر الكونية, والنظريات هي صياغة عامة لتفسير كيفية حدوث تلك الظواهر ومسبباتها, أما الحقائق الكونية فهي مايثبت ثبوتا قاطعا في علم الإنسان بالأدلة المنطقية المقبولة وهي جزء من الحكمة التي نحن أولى الناس بها, وكذلك القوانين العلمية فهي تعبيرات بشرية عن السنن الإلهية في الكون, تصف علاقات محددة تربط بين عناصر الظاهرة الواحدة, أو بين عدد من الظواهر الكونية المختلفة, وهي كذلك جزء من الحكمة التي أمرنا بأن نجعلها ضالة المؤمن.
بقلــــــــم الدكتور زغول النجار.[u]
- اقتباس :