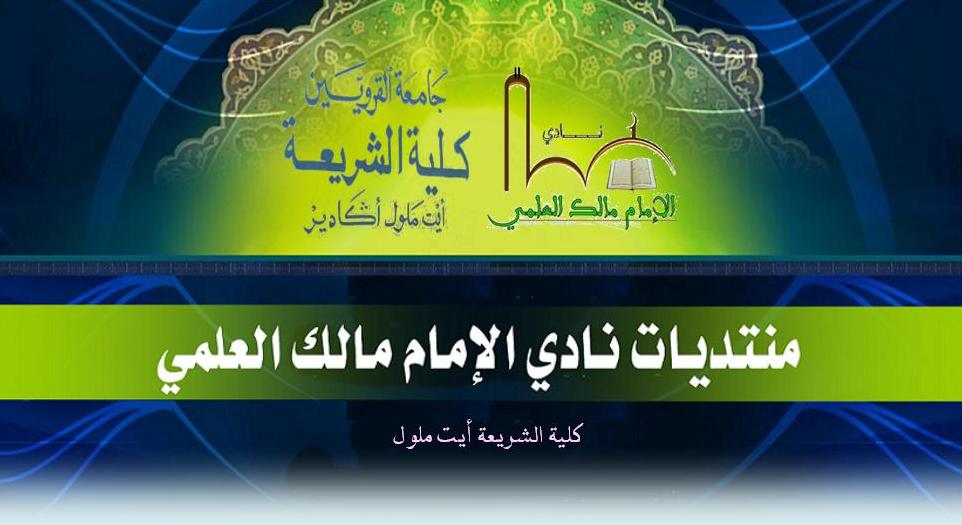ــ حرص كثير من علماء المسلمين, على ألا يتم تأويل الإشارات العلمية, الواردة في القرآن الكريم إلا في ضوء الحقائق العلمية المؤكدة من القوانين والقواعد الثابتة, أما الفروض والنظريات فلا يجوز تخديمها في فهم ذلك وحتي هذا الموقف نعتبره تحفظا مبالغا فيه, فكما يختلف دارسو القرآن الكريم في فهم بعض الدلالات اللفظية, والصور البيانية, وغيرها من القضايا اللغوية ولا يجدون حرجا في ذلك العمل الذي يقومون به في غيبة نص ثابت مأثور, فاننا نري أنه لا حرج علي الإطلاق في فهم الاشارات الكونية الواردة بالقرآن الكريم علي ضوء المعارف العلمية المتاحة, حتي ولو لم تكن تلك المعارف قد ارتقت إلي مستوي الحقائق الثابتة, وذلك لأن التفسير يبقي جهدا بشريا خالصا ـ بكل ما للبشر من صفات القصور, والنقص, وحدود القدرة, ثم ان العلماء التجريبيين قد يجمعون علي نظرية ما. لها من الشواهد ما يؤيدها, وان لم ترق بعد الي مرتبة القاعدة أو القانون, وقد لا يكون أمام العلماء من مخرج للوصول بها الي ذلك المستوي أبدا, فمن أمور الكون العديدة مالا سبيل للعلماء التجريبيين من الوصول فيها الي حقيقة أبدا, ولكن قد يتجمع لديهم من الشواهد مايمكن أن يعين علي بلورة نظرية من النظريات, ويبقي العلم التجريبي مسلما بأنه لا يستطيع أن يتعدي تلك المرحلة في ذلك المجال بعينه أبدا, والأمثلة علي ذلك كثيرة منها النظريات المفسرة لأصل الكون وأصل الحياة وأصل الإنسان, وقد مرت بمراحل متعددة من الفروض العلمية حتي وصلت اليوم الي عدد محدود من النظريات المقبولة, ولا يتخيل العلماء أنهم سيصلون في يوم من الأيام الي أكثر من تفضيل لنظرية علي أخري, أو تطوير لنظرية عن أخري, أو وضع لنظرية جديدة, دون الادعاء بالوصول الي قانون قطعي, أو قاعدة ثابتة لذلك, فهذه مجالات إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية فإنه يضل فيها ضلالا بعيدا, وصدق الله العظيم اذ يقول:
(ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا). (الكهف51)
وذلك لأنه على الرغم من أن العلماء التجريبيين يستقرئون حقائق الكون بالمشاهدة والاستنتاج, أو بالتجربة والملاحظة والاستنتاج, في عمليات قابلة للتكرار والاعادة, إلا أن من أمور الكون مالا يمكن إخضاعه لذلك من مثل قضايا الخلق: خلق الكون, وخلق الحياة وخلق الانسان. وهي قضايا لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى تصور صحيح أبدا بغير هداية ربانية, ولولا الثبات في سنن الله التي تحكم الكون ومافيه ما تمكن الانسان من اكتشافها,... ولا يظن عاقل أن البشر مطالبون بما هو فوق طاقاتهم ـ خاصة في فهم كتاب الله ـ الذي أنزل لهم, ويسر لتذكرهم لقول الحق تبارك وتعالي:
(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)( القمر: الآيات40,32,22,17)
ففي الوقت الذي يقرر القرآن الكريم فيه أن الله لم يشهد الناس خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم, نجده في آيات أخر يأمرهم بالنظر في كيفية بداية الخلق, وهي من أصعب قضايا العلوم الكونية البحتة منها والتطبيقية قاطبة اذ يقول عز من قائل:
(أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير* قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأخرة إن الله على كل شيء قدير) (العنكبوت:20,19)
مما يشير إلى أن بالأرض سجلا حافلا بالحقائق التي يمكن أن يستدل منها على كيفية الخلق الأول, وعلى إمكانية النشأة الآخرة, والأمر في الآية من الله تعالى إلى رسوله الكريم ليدع الناس كافة إلى السير في الأرض, واستخلاص العبرة من فهم كيفية الخلق الأول, وهي قضية تقع من العلوم الكونية( البحتة والتطبيقية) في الصميم, إن لم تكن تشكل أصعب قضية علمية عالجها الإنسان.
وهذه القضايا: قضايا الخلق وإفنائه وإعادة خلقه لها في كتاب الله وفي سنة رسوله( صل الله عليه وسلم) من الإشارات اللطيفة مايمكن الإنسان المسلم من تفضيل نظرية من النظريات أو فرض من الفروض والارتقاء بها أو به إلى مقام الحقيقة لمجرد ورود ذكر لها أو له في كتاب الله أو في سنة رسوله( صل الله عليه وسلم) ونكون بذلك قد انتصرنا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة للعلم وليس العكس.
وعلى ذلك فإني أرى جواز فهم الاشارات العلمية الواردة بالقرآن الكريم على أساس من الحقائق العلمية الثابتة أولا, فإن لم تتوافر فبالنظرية السائدة, فإن لم تتوافر فبالفرض العلمي المنطقي المقبول, حتى لو أدى التطور العلمي في المستقبل إلى تغيير تلك النظرية, أو ذلك الفرض أو تطويرهما أو تعديلهما, لأن التفسير ـ كما سبق أن أشرت يبقي اجتهادا بشريا خالصا من أجل حسن فهم دلالة الآية القرآنية إن أصاب فيه المرء فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد, ويبقى هذا الاجتهاد, قابلا للزيادة والنقصان, وللنقد والتعديل والتبديل.
الرد على القائلين بعدم جواز رؤية كلام الله في إطار محاولات البشر
إن في كون القرآن الكريم بيانا من الله تعالى إلى الناس كافة, يفرض على المتخصصين من أبناء المسلمين أن يفهموه ـ كل في حقل تخصصه ـ على ضوء ماتجمع له من معارف بتوظيف مناهج الإستقراء الدقيقة, فالقرآن نزل للناس ليفهموه وليتدبروا آياته. ثم إن تأويل آيات الكونيات على ضوء من معطيات العلوم التجريبية لا يشكل احتجاجا على القرآن بالمعارف المكتسبة, ولا انتصارا له بها, فالقرآن بالقطع ـ فوق ذلك كله, ولأن التأويل على أساس من المعطيات العلمية الحديثة يبقى محاولة بشرية للفهم في إطار لم يكن متوفرا للناس من قبل, ولا يمكن أن تكون محاولات البشر لفهم القرآن الكريم حجة على كتاب الله, سواء أصابت أم أخطأت تلك المحاولات, وإلا لما حفل القرآن الكريم بهذا الحشد الهائل, من الآيات التي تحض على استخدام كل الحواس البشرية للنظر في مختلف جنبات الكون بمنهج علمي استقرائي دقيق. وذلك لأن الله تعالى قد جعل السنن الكونية على قدر من الثبات والاطراد يمكن حواس الإنسان المتأمل لها, المتفكر فيها, المتدبر لتفاصيلها من إدراك أسرارها( على الرغم من حدود قدرات تلك الحواس), ويعين عقله على فهمها( على الرغم من حدود قدرات ذلك العقل),
وربما كان هذا هو المقصود من آيات التسخير التي يزخر بها القرآن الكريم, ويمن علينا ربنا تبارك وتعالي ـ وهو صاحب الفضل والمنة ـ بهذا التسخير الذي هو من أعظم نعمه علينا نحن العباد.
ومن أروع مايدركه الإنسان المتأمل في الكون كثرة الأدلة المادية الملموسة على كل حدث وقع في الكون صغر أم كبر, أدلة مدونة في صفحة الكون وفي صخور الأرض بصورة يمكن لحواس الإنسان ولعقله إدراكها لو اتبع المنهج العلمي الاستقرائي الصحيح, فما من انفجار حدث في صفحة الكون إلا وهو مدون, ومامن نجم توهج أو خمد إلا وله أثر, وما من هزة أرضية أو ثورة بركانية أو حركة بانية للجبال إلا وهي مسجلة في صخور القشرة الأرضية, وما من تغير في تركيب الغلاف الغازي أو المائي للأرض إلا وهو مدون في صخور الأرض, ومامن تقدم للبحار أو انحسار لها, ولا تغير في المناخ إلا وهو مدون كذلك في صخور الأرض, ومامن هبوط نيازك أو أشعة كونية على الأرض إلا وهو مسجل. في صخورها. ومن هنا فإن الدعوة القرآنية للتأمل في الكون واستخلاص سنن الله فيه وتوظيف تلك السنن في عمارة الأرض والقيام بواجب الاستخلاف فيها هي دعوة للناس في كل زمان ومكان, وهي دعوة لا تتوقف ولا تتخلف ولا تتعطل انطلاقا من الحقيقة الواقعة أنه مهما اتسعت دائرة المعرفة الإنسانية فإن القرآن الكريم يبقي ـ دوما ـ مهيمنا عليها, محيطا بها لأنه كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وقدرته وحكمته, والذي هو أدرى بصنعته من كل من هم سواه.
وعلى ذلك فإن مقابلة كلام الله بمحاولة البشر لتفسيره وإثبات جوانب الإعجاز فيه لا تنتقص من جلال الربوبية الذي يتلألأ بين كلمات هذا البيان الرباني الخالص, وإنما تزيد المؤمنين ثباتا على إيمانهم, وتقيم الحجة على الجاحدين من الكفار والمشركين, وحتى لو أخطأ المفسر في فهم دلالة أية من آيات القرآن الكريم فإن هذا الخطأ يعد على المفسر نفسه ولا ينسحب على جلال كلام الله أبدا, والذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأوا, وكذلك الذين فسروا بالتاريخ, فليحاول العلماء التجريبيون تفسير الآيات الكونية بما تجمع لديهم من معارف لأن تلك الآيات لا يمكن فهم دلالاتها فهما كاملا, ولا استقراء جوانب الإعجاز فيها في حدود أطرها اللغوية وحدها.
الرد على المدعيــــــن بكفـــــر الكتـابــات العلميــــة المعــــاصــــرة:
إن الإحتجاج بأن العلوم التجريبية ـ في ظل الحضارة المادية المعاصرة ـ تنطلق في معظمها من منطلقات مادية بحتة, تنكر أو تتجاهل الغيب, ولا تؤمن بالله, وأن للكثيرين من المشتغلين بالعلوم مواقف عدائية واضحة من قضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, فمرده بعيد عن طبيعة العلوم الكونية, وإنما يرجع ذلك إلى العقائد الفاسدة التي أفرزتها الحضارة المادية المعاصرة, والتي تحاول فرضها على كل استنتاج علمي كلي, وعلى كل رؤية شاملة للكون والحياة, في وقت حققت فيه قفزات هائلة في مجال العلوم الكونية البحتة منها والتطبيقية, بينما تخلف المسلمون في كل أمر من أمور الحياة بصفة عامة, وفي مجال العلوم والتقنية بصفة خاصة, مما أدى إلى انتقال القيادة الفكرية في هذه المجالات على وجه الخصوص إلى أمم سبق للعلماء فيها أن عانوا معاناة شديدة من تسلط الكنيسة عليهم, واضطهادها لهم, ورفضها للمنهج العلمي ولكل معطياته ووقوفها حجر عثرة في وجه أي تقدم علمي, كما حدث في أوروبا في أوائل عصر النهضة. فانطلق العلماء الغربيون من منطلق العداوة للكنيسة أولا ثم لقضية الإيمان بالتبعية, وداروا بالعلوم الكونية ومعطياتها في إطارها المادي فقط, وبرعوا في ذلك براعة ملحوظة, ولكنهم ضلوا السبيل وتنكبوه حينما حبسوا أنفسهم في إطار المادة, ولم يتمكنوا من إدراك ما فوقها, أو منعوا أنفسهم من التفكير فيه, فأصبحت الغالبية العظمى من العلوم تكتب من مفهوم مادي صرف, وانتقلت عدوى ذلك إلى عالمنا المسلم أثناء مرحلة اللهث وراء اللحاق بالركب التي نعيشها وما صاحب ذلك من مركبات الشعور بالنقص, أو نتيجة لدس الأعداء, وانبهار البلهاء بما حققته الحضارة المادية المعاصرة من انتصارات في مجال العلوم البحتة والتطبيقية, وما وصلت إليه من أسباب القوة والغلبة, وما حملته معها حركة الترجمة من غث وسمين, فأصبحت العلوم تكتب اليوم في عالمنا المعاصر من نفس المنطلق لأنها عادة ماتدرس وتكتب وتنشر بلغات أجنبية على نفس النمط الذي أرست قواعده الحضارة المادية, وحتى ما ينشر منها باللغة العربية, أو بغيرها من اللغات المحلية, لا يكاد يخرج في مجموعه عن كونه ترجمة مباشرة أو غير مباشرة للفكر الغريب الوافد بكل مافيه من تعارض واضح أحيانا مع نصوص الدين, وهنا تقتضي الأمانة اثبات أن ذلك الموقف غريب على العلم وحقائقه ومن هنا أيضا كان من واجب المسلمين إعادة التأصيل الإسلامي للمعارف العلمية أي إعادة كتابة العلوم بل والمعارف المكتسبة كلها من منطلق إسلامي صحيح خاصة أن المعطيات الكلية للعلوم البحتة والتطبيقية ـ بعد وصولها إلى قدر من التكامل في هذا العصر ـ أصبحت من أقوى الأدلة على وجود الله وعلى تفرده بالألوهية والربوبية وبكامل الأسماء والصفات, وأنصع الشواهد على حقيقة الخلق وحتمية البعث وضرورة الحساب وأن العلوم الكونية كانت ولا تزال النافذة الرئيسية التي تتصل منها الحضارة المعاصرة بالفطرة الربانية وأن المنهج العلمي ونجاحه في الكشف عن عدد من حقائق هذا الكون متوقف على اتساق تلك الفطرة واتصاف سننها بالاطراد والثبات.
الرد على الادعــــــاء بالتعـــــارض بيـــن معطيــــــات العلــــم والديـــــن:
إن القول بأن عددا من المعطيات الكلية للعلوم التجريبية ـ كما تصاغ في الحضارة المادية المعاصرة ـ قد تتباين مع الأصول الإسلامية الثابتة ـ قول على إطلاقه غير صحيح لأنه إذا جاز ذلك في بعض الإستنتاجات الجزئية الخاطئة, أو في بعض الأوقات كما كان الحال في مطلع هذا القرن, والمعرفة بالكون جزئية متناثرة, ساذجة بسيطة, أو في الجزء المتأخر منه عندما أدت المبالغة في التخصص إلى حصر العلماء في دوائر ضيقة للغاية حجبت عنهم الرؤية الكلية لمعطيات العلوم, فإنه لا يجوز:اليوم حين بلغت المعارف بأشياء هذا الكون حدا لم تبلغه البشرية من قبل وقد أصبحت الإستنتاجات الكلية لتلك المعارف تؤكد ضرورة الإيمان بالخالق الباريء المصور الذي ليس كمثله شيء, وعلى ضرورة التسليم بالغيب وبالوحي وبالبعث وبالحساب, فمن المعطيات الكلية للعلوم الكونية المعاصرة ما يمكن إيجازه فيما يلي:
-أن هذا الكون الذي نحيا فيه متناه في أبعاده مذهل في دقة بنائه, مذهل في إحكام ترابطه وانتظام حركاته.
-أن هذا الكون مبني علي نفس النظام من أدق دقائقه إلي أكبر وحداته.
-أن هذا الكون دائم الاتساع إلي نهاية لا يستطيع العلم المكتسب إدراكها.
ـ أن هذا الكون ـ على قدمه ـ مستحدث مخلوق, كانت له في الماضي السحيق بداية حاول العلم التجريبي قياسها, ووصل فيها إلى دلالات تكاد تكون ثابتة ـ لو استبعدنا الأخطاء التجريبية.
ـ إن هذا الكون عارض أي أنه لابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية تشير إليها كل الظواهر الكونية من حولنا.
ـ إن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه ولا يمكن لأي من مكوناته المادية أن تكون قد أوجدته.
ـ إن هذا الكون المتناهي الأبعاد. الدائم الاتساع, المحكم البناء, الدقيق الحركة والنظام الذي يدور كل ما فيه في مدارات محددة وبسرعات مذهلة متفاوتة وثابتة لا يمكن أن يكون قد وجد بمحض المصادفة.
ـ هذه المعطيات السابقة تفضي إلى حقيقة منطقية واحدة مؤداها أنه اذا كان هذا الكون الحادث لا يمكن أن يكون قد وجد بمحض المصادفة. فلابد له من موجد عظيم له من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من صفات الكمال والتنزيه ما لا يتوافر لشيء من خلقه بل ما يغاير صفات المخلوقات جميعا فلا تحده. حدود المكان ولا الزمان ولا قوالب المادة أو الطاقة, ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا ينسحب عليه ما يحكم خلقه من سنن وقوانين, لأنه( سبحانه وتعالى)
( ليس كمثله شيء)( الشوري:11)
ـ هذا الخالق العظيم الذي أوجد الكون بما فيه ومن فيه هو وحده الذي يملك القدرة على إزالته وإفنائه ثم إعادة خلقه وقتما شاء وكيفما شاء:
(يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب, كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين).(الأنبياء: آية103)
(إنما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون)( النحل:40)
ـ إن الوحدة في هذا الكون تشير إلى وحدانية هذا الخالق العظيم, وحدة بناء كل من الذرة والخلية الحية والمجموعة الشمسية والمجرة وغيرها, ووحدة تأصيل العناصر كلها وردها إلى أبسطها وهو غاز الإيدروجين, ووحدة تواصل كل صور الطاقة, وتواصل المادة والطاقة, وتواصل المخلوقات, هذا التواصل وتلك الوحدة التي يميزها التنوع في أزواج, وتلك الزوجية التي تنتظم كل صور المخلوقات من الأحياء والجمادات تشهد بتفرد الخالق الباريء المصور بالوحدانية, واستعلاء هذا الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد فوق خلقه بمقام الألوهية والربوبية الذي لا يشاركه فيه أحد ولا ينازعه على سلطانه منازع ولا يشبهه من خلقه شيء.
ـ إن العلوم التجريبية في تعاملها مع المدرك المحسوس فقط, قد استطاعت أن تتوصل إلى أن بالكون غيبا قد لا يستطيع الإنسان أن يشق حجبه, ولولا ذلك الغيب ما استمرت تلك العلوم في التطور والنماء, لأن أكبر الإكتشافات العلمية قد نمت نتيجة للبحث الدءوب عن هذا الغيب.
ـ تؤكد العلوم التجريبية أن بالأحياء سرا لا نعرف كنهه, لأننا نعلم مكونات الخلية الحية, والتركيب المادي لجسد الانسان, ومع ذلك لم يستطع هذا العلم أن يصنع لنا خلية حية واحدة, أو أن يوجد لنا إنسانا عن غير الطريق الفطري لإيجاده.
ـ إن النظر في أي من زوايا هذا الكون ليؤكد حاجته ـ بمن فيه وما فيه ـ إلى رعاية خالقه العظيم في كل لحظة من لحظات وجوده.
ـ إن العلوم الكونية إذ تقدر أن الكون والإنسان في شكليهما الحاليين ليسا أبديين, فإنها ـ وعلى غير قصد منها ـ لتؤكد حقيقة الآخرة, بل وعلى حتميتها, والموت يتراءي في مختلف جنبات هذا الكون في كل لحظة من لحظات وجوده, شاملا الإنسان والحيوان والنبات والجماد وأجرام السماء على تباين هيئاتها, وتكفي في ذلك الإشارة إلى ما أثبتته المشاهدة من أن الشمس تفقد من كتلتها بالإشعاع ما يقدر بحوالي4,6 مليون طن في كل ثانية وإنها إذ تستمر في ذلك فلابد من أن يأتي الوقت الذي تخبو فيه جذوتها, وينطفيء أوراها, وتنتهي الحياة على الأرض قبل ذلك, لاعتمادها في ممارسة أنشطتها الحيوية على أشعة الشمس وأن الطاقة تنتقل من الأجسام الحارة إلى الأجسام الأقل حرارة بطريقة مستمرة في محاولة لتساوي درجات حرارة الأجرام المختلفة في الكون ولابد أن تنتهي بذلك أو قبله كل صور الحياة المعروفة لنا, وليس معنى ذلك أنه يمكن معرفة متى تكون نهاية هذا الوجود, لأن الآخرة قرار إلهي لا يرتبط بسنن الدنيا, وإن أبقى الله تعالى لنا في الدنيا من الظواهر والسنن ما يؤكد إمكانية وقوع الآخرة, بل حتميتها انصياعا للأمر الإلهي "كن فيكون" وأن الإنسان الذي يحوي جسده في المتوسط ألف مليون مليون خلية يفقد فيها في كل ثانية ما يقدر بحوالي125 مليون خلية تموت ويتخلق غيرها بحيث تتبدل جميع خلايا جسد الفرد من بني البشر مرة كل عشر سنوات تقريبا, فيما عدا الخلايا العصبية التي إذا ماتت لا تتجدد, وتكفي في ذلك أيضا الإشارة إلى أن انتقال الإليكترون من مدار إلى آخر حول نواة الذرة يتم بسرعة مذهلة دفعت بعدد من العلماء إلى الاعتقاد بأنه فناء في مدار وخلق جديد في مدار آخر, كما تكفي الإشارة إلى ظاهرة اتساع الكون عن طريق تباعد المجرات عن بعضها البعض بسرعات مذهلة تقترب من سرعة الضوء( أي حوالي ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية) وتخلق المادة في المسافات الجديدة الناتجة عن هذا التباعد المستمد بطريقة لايعلمها إلا الله, وتباطؤ هذا التباعد الناتج عن ظاهرة الإنفجار العظيم مع الزمن مما يشير إلى حتمية تغلب الجاذبية على عملية الدفع إلى الخارج مما يؤدي إلى إعادة جمع مادة الكون ومختلف صور الطاقة فيه في جرم واحد ذي كثافة بالغة مما يجعله في حالة من عدم الإستقرار تؤدي إلى انفجاره على هيئة شبيهة بالإنفجار الأول الذي تم به خلق الكون, فيتحول هذا الجرم إلى غلالة من دخان كما تحول الجرم الأول, وتتخلق من هذا الدخان أرض غير الأرض, وسماوات غير السماوات.
كما وعد ربنا تبارك وتعالى بقوله( عز من قائل):
(يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين)( الأنبياء: آية103)
وقوله( سبحانه):
(يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار)( إبراهيم:50).
وتكفي في ذلك أيضا الإشارة إلى أن الذرات في جميع الأحماض الأمينية والجزيئات البروتينية تترتب ترتيبا يساريا في أجساد كافة الكائنات الحية على اختلاف مراتبها, فإذا مامات الكائن الحي أعادت تلك الذرات ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة محددة يمكن باستخدامها تحديد لحظة وفاة الكائن الحي اذا بقيت من جسده بقية بعد مماته, ويتعجب العلماء من القدرة التي مكنت الذرات من تلك الحركات المنضبطة بعد وفاة صاحبها وتحلل جسده!!
فهل يمكن لعاقل بعد ذلك أن يتصور أن العلوم الكونية ومعطياتها في أزهى عصور ازدهارها ـــ تتصادم مع قضية الإيمان بالله, وهذه هي معطياتها الكلية, وهي في جملتها تكاد تتطابق مع تعاليم السماء, وفي ذلك كتب المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ محمد فريد وجدي( يرحمه الله) في خاتمة كتابه المستقبل للإسلام ما نصه:
"إن كل خطوة يخطوها البشر في سبيل الرقي العلمي, هي تقرب إلى ديننا الفطري, حتى ينتهي الأمر إلى الإقرار الإجماعي بأنه الدين الحق."
ثم يضيف:.. نعم إن العالم بفضل تحرره من الوراثات والتقاليد, وإمعانه في النقد والتمحيص, يتمشى على غير قصد منه نحو الإسلام,بخطوات متزنة ثابتة, لاتوجد قوة في الأرض ترده عنه إلا إذا انحل عصام المدنية, وارتكست الجماعات الإنسانية عن وجهتها العلمية.
وقد بدأت بوادر هذا التحول الفكري تظهر جلية اليوم, وفي مختلف جنبات الأرض, بإقبال أعداد كبيرة من العلماء والمتخصصين وكبار المثقفين والمفكرين على الاسلام, إقبالا لم تعرف له الإنسانية مثيلا من قبل, وأعداد هؤلاء العلماء الذين توصلوا إلى الايمان بالله عن طريق النظر المباشر في الكون, واستدلوا على صدق خاتم رسله وأنبيائه( صل الله عليه وسلم) بالوقوف على عدد من الإشارات العلمية البارقة الصادقة في كتاب الله, هم في تزايد مستمر, وهذا واحد منهم موريس بوكاي الطبيب والباحث الفرنسي يسجل في كتابه الإنجيل والقرآن والعلم مانصه:.. "لقد أثارت هذه الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية, فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير ـ إلى هذا الحد ــ من الدعاوي الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقة تماما للمعارف العلمية الحديثة, وذلك في نص دون منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا."
بقلم الدكتور زغلول النجار