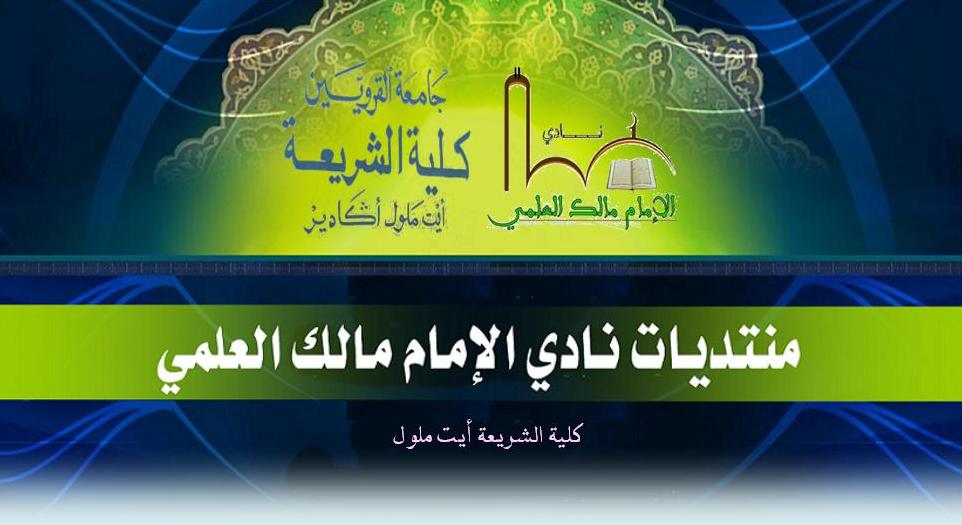أفلا نعتبرُ ونتعظُ –يا إخوة السُّنّة والإسلام-؟! إنَّ الناظر في واقعِ الدعوةِ السلفيَّة المعاصرة:
يفرحُ –من جهةٍ- ذلك لانتشار هذه الدعوةِ الميمونةِ، وإقبالِ الناس عليها، ومعرفة الخاصّةِ والعامّةِ لحقيقتها… ويَأسى –من جهةٍ أُخرى-: لمَّا يرى ما هُو حادث في (بعض البلاد) مِن تدابُر، وتناحُر، وتناطُح، وتخاصُم، بل بتبديع وتشنيع!! ممَّا جَعَلَ –في المقابل- أناساً (!) يَنْحَون منحى التمييع والتضييع!!
ولو نَظَرْتَ وتأمَّلْتَ: لا تكادُ تجدُ الكثيرين (!) –من هؤلاء وأولئك- يميِّزون أسباب هذا الخلاف، أو أبواب ذاك الاختلاف!
ومَن عرف منهم: فإنَّه (قد) لا يدري الوجوهَ الشرعيّةَ المتعلّقة بهذا الأمرِ من الولاء والبراء!
ومن درى منهم: فإنَّه (قد) لا يُدرك الآثار، والتَّبعات المتحقِّقة على صيغةِ هذا: تأثيراً على الدعوة، وأثراً على دُعاتها!!
ومَن أدرك منهم: فإنَّه (قد) لا يستحضِرُ –إلا من رَحِمَ الله- حقيقة معنى قولِ النبي –صلى الله عليه وسلم-: ((لا يؤمن أحدُكم حتى يُحبّ لأخيهِ ما يُحبُّ لنفسه من الخير))!
مِمَّا يخلِطُ أمامه الحقائق، ويضرب بين يديه الأولويَّات بعضها ببعض، ويُغيِّبُ من عينهِ المسلَّمات!!
ولا قوَّة إلا بالله…
فها هي –ذي- كلماتُ الإمام ابن قُتيبة الدِّينوريِّ( ) –المتوفّى سنة (276هـ)- في كتابِهِ ((الاختلاف باللفظِ)) (ص11-13 – بتلخيص يسير) –في واقعةٍ من أعظم الوقائع التي ضربت أهل السنّة بفتنة من فتن أهل البدع؛ حتى أَثَّرت في صفوفهم تأثيراً عظيماً جدّاً-، وهي فتنة (خلق القرآن)، و (اللفظ) فقال ناصحاً ومرشداً، بشفقةٍ، وصدقٍ، وإخلاص-:
((وكان آخر ما وقع من الاختلاف أمراً خُصَّ بأصحاب الحديث، الذين لم يزالوا بالسنّةِ ظاهرين، وبالاتباعِ قاهرين,… إلى أن كادهم الشيطانُ بمسألة لم يجعلها الله –تعالى- أصلاً في الدين ولا فرعاً، في جهلها سعةٌ، وفي العلم بها فضيلةٌ، فنمى شرُّها، وعَظُمَ شأنُها، حتى فرَّقت جماعتهم، ووهنتْ أمرَهم، وأشمتت حاسديهم، وكَفَتْ عدوَّهم مؤنتهم بألسنتهم وعلى أيديهم، فهو دائبٌ يضحك منهم، ويستهزئ بهم، حيث رأى بعضَهم يكفِّرُ بعضاً، وبعضَهم يلعنُ بعضاً، ورآهم مختلفين وهم كالمتَّفقين، ومتباينين وهم كالمجتمعين، ورأى نفسَه صار سَلَماً بعد أن كان حرباً…
ثم انتهى بنا القولُ إلى غرضِنا من هذا الكتاب، وغايتِنا من اختلاف أهل الحديث في اللفظ بالقرآن، وتشانئهم وإكفارِ بعضهم بعضاً، وليس ما اختلفوا فيه ممَّا يقطعُ الألفة، ولا ممَّا يُوجب الوحشة؛ لأنَّهم مُجمعون على أصلٍ واحدٍ وهو: ((القرآنُ كلامُ الله غير مخلوق)).
وإنما اختلفوا في فرعٍ –لم يفهموه- لغموضةِ ولُطفِ معناه، فتعلَّقَ كلُّ فريقٍ منهم بشعبةٍ منه، ولم يكن معهم آلة التمييز، ولا فحصُ النظَّارين، ولا علمُ أهل اللغة…
وكلُّ من ادَّعى شيئاً، أو انتحل نِحلة، فهو يزعُم أنَّ الحقَّ فيما ادَّعى، وفيما انتحل، خلا الواقف الشاكَّ، فإنَّه يُقِرُّ على نفسِه بالخطأ؛ لأنه يعلمُ أنَّ الحقَّ في أحد الأمرَيْن الذين وقف بينهما، وأنه ليس على واحد منهما.
وقد بُلِي بالفريقَيْن المستبصرُ المسترشدُ –يعني به: الواقفَ الشاكَّ-، وبإعانتِهم وإغلاظهم لمن خالفهم، وإكفاره وإكفارِ من شكَّ في كفرِه، فإنه ربما وردَ الشيخُ المصرَ، فقعد للحديث، وهو من الأدب عُفلٌ ومن التمييز، ليس له من معاني العلم إلا تقادمُ سِنِّهِ، وإنْ قد سمع ابنَ عيينة وأبا معاويةَ ويزيدَ بنَ هارون، وأشباهَهُم، فيبدؤونه –قبل الكتاب-ِ بالمحنةِ! فالويلُ له إن تلعثمَ أو تمكَّثَ أو سعلَ أو تنحنحَ، قبل أن يُعطيَهم ما يُريدونَه، فيحملُهُ الخوفُ من قدحِهم فيه وإسقاطِهم له، على أن يعطيَهم الرضا، فيتكلَّم بغير علم، ويقولَ بغيرِ فَهم، فيتباعد من اللهِ في المجلسِ الذي أمّل أن يتقرَّب فيه منه، وإن كان ممَّن يعقِدُ على مخالفتهم؛ سامَ نفسَه إظهارَ ما يُحبُّون، ليكتبوا عنه.
وإن رأوا حدثاً مسترشداً، أو كَهْلاً متعلِّماً سألوه، فإن قال لهم: أنا أطلب حقيقة هذا الأمر وأسألُ عنه، ولم يصحَّ لي شيءٌ بَعْدُ، وإنما صدقهم عنه نفسِه، واعتذر بعُذرٍ اللهُ يعلمُ صِدقَهُ، وهم يعلمون أنَّ الله لم يكلِّفه –إذا لم يعلمْ- إلا أنْ يسألَ ويبحثَ ليعلمَ: كذَّبوهُ، وآذوه، وقالوا: خبيثٌ فاهجروه ولا تقاعدوه!
أفترى: لو كان ما هم عليه من اعتقادهم هذا الأمرَ أصلَ التوحيدِ الذي لا يجوزُ للناسِ أن يجهلوه، وقد سمعوهُ من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- مشافهة، أكان يجب أن يُبلَغَ فيه هذه الغاية؟…)).
قلتُ: فبالله عليك –أيها الصدوقُ-: أليس هذا يُشبه –إلى حدٍّ كبير جدّاً- ما نحن فيه؟! أو ما نكادُ نَصِلُ إليه؟!
لُطفك اللهم…
وأمَّا الشيخُ العلامةُ الإمامَ جمالُ الدين القاسميُّ –المتوفّى سنة (1332هـ) –رحمه الله- فقد قال في كتابه ((تاريخ الجهميّة والمعتزلة)) (ص69 – 70) تنبيهاً، وتحذيراً، وتصحيحاً –ما نصُّه-:
((وبالجملةِ؛ من أعظمِ آفاتِ التعصب: ما نشأ عنه من التَّفرُّق والتعادي بحيث صار يرثه المتأخِّرُ عن المتقدِّم، حتى أصبح يُبغضُ القريبُ قريبَه إذا وجده يخالف رأيه، ويلصقُ به كلَّ تهمةٍ شنعاءَ ولو أقام على صحةِ رأيه من البراهين، بل بلغ احتقارُ بعضهم لبعضٍ مبلغاً دفعَ به إلى أن يحنق على مخالفه، ويتحيَّنَ الفُرصَ للإيقاع به، حتى إذا بدرَتْ منه هفوةٌ، أو ظهرت زلَّةٌ –ولا معصوم إلا من عَصمَ الله-؛ رفع مُخالفُه عقيرته بتأنيبه، وملأَ الأرضَ والسماءَ صراخاً بتشهيرِه، غير مبالٍ بما حظرَه الشرعُ ممَّا يولِّدُ البغضاء والشحناء، ويُفكِّكُ عُرى الإخاء، ولا ملامَ على الدهماءِ من ترويجِ مثل هذه الخطَّةِ الشائنةِ لغرقهم في بحارِ الجهلِ، إنما يُلام قادةُ الأفكارِ على احتذائِهم هذا الحذوَ، ونسجهِم على هذا المنوالَ؛ إذ لولا صخبُ هؤلاءِ الرهطِ وبثَّهم هذه الألقاب في النفوسِ، لكانت الأمةُ متماسكةَ الأجزاءِ، متينةَ عرى المحبةِ بين الأفراد.
نعم؛ لا بأس أن تُنتقدَ الأقوالُ، وتُضعَّفُ بالبرهانِ، ويُوضِّح كلُّ خطأٍ ينجُم عنها، ولكن الذي يجبُ التوقِّي منه: هو أن يتشاحنَ قادةُ العقولِ ويتناطحوا ويتباغضوا لِما لا يصحُّ أن يكون سبباً معقولاً، وأن يَثِبَ كلٍّ على مخالِفيه وثبةَ الغادِرِ المنتقم، فيودّ أن يُنكل به أو يمزّقه شرّ ممزَّق، فيقتفي أثَرهم مقلِّدُهُم، فتُصبِحَ الأمّة أعداءً متشاكِسة، وأحزاباً متنافِرة، بشؤم التَّعصُّب الذميم، الذي لم يتمكن من أمَّةٍ إلا وذهب بها مذهَب التَّفرُّق والانحطاط، وأضعف قواها، وأحاق بها الخطوبَ والأرزاء، فمن الواجبِ العملُ على ملاشاةِ الشحناءِ والشقاق، والقيام بالتَّحابّ والاتفاق، وباللهِ التوفيق)).